لا أعلم عنكم ولكن أنا من جيل قناة سبيستون التي انطلقت في عام ٢٠٠٠م عندما كنت طفلة في التاسعة. بالنسبة لي لم تكن هذه القناة مجرد قناة تعرض أفلام الكرتون فقط بل كانت محطة مليئة بالإبداع في العرض من تصنيف أفلام الكرتون حسب الكواكب وعرض الأفكار التعليمية والتي أثرت علي بشكلٍ كبير.
إحدى فقرات القناة التي أحبها جدًا هي فقرة (الرابط العجيب)، التي لم أستوعب حينها المعنى العميق وراء هذه الفكرة العظيمة – إيجاد رابط بين شيئين مختلفين جدًا-، وهي أن الأمور في حياتنا مترابطة بشكل أكبر مما نراه أو نعتقده. وكنت دومًا أتابع الفقرة بتركيز عالي والتي أنهيها دائمًا بالوصول إلى لحظة (أهاااااااا).
وبحكم طريقة تعليمنا التقليدي والتلقيني، والتي لم نتعلم ونتعود فيها بأن نعكس المفاهيم التي نتعلمها على واقع حياتنا، لذلك لم يخطر ببالي يومًا أن أجد الرابط العجيب بين أمرين مختلفين في حياتي. حتى اصطدمت بحقائق جديدة اكتشفتها مؤخرًا واكتشفت من خلالها إحدى الروابط العجيبة في قصتي.
بدأت قصتي عندما كنت بالصف الثاني الابتدائي- أو لعلي لا أذكر ما هو أقدم من هذا العمر-، وقتها كرهت مادة التربية الفنية والرسم كرهًا أبديًا. وذلك بسبب معلمة المادة نفسها، حين رأتني أقوم ببري الألوان الخشبية بكثرة حتى تقلص حجم أغلب الألوان وأصبح طول البعض منها أقصر من الأصبع. أتذكر عندما نادتني وقالت لي بنبرة حادة: (تعالي وهاتي ألوانك). قمت من مكاني وفي يدي الصغيرة علبة الألوان التي أعطيتها إياها. أمسكت إحدى الألوان ونظرت إلي: (ايش هذا؟؟ ليش كل ألوانك قصيرة كذا!!) ومرة أخرى قالتلها بنبرة حادة، ولم أجد إجابة وقتها غير الصمت. عندها قالت لي: (حتنقصي درجتين على هذه الألوان).
وقتها لم أكن أعلم بعد معنى الدرجات، ولكن علمت ذلك بنهاية الفصل الدراسي حينما حصلت على المرتبة الثامنة بسبب هاتين الدرجتين، بالرغم من أن جميع درجاتي كانت كاملة في جميع المواد. وأتذكر إحدى معلماتي التي أحبها جدًا قالت لي: (أسماء أنا تفاجأت!! كنت متأكدة أنك حتحصلي على المرتبة الأولى لأنك شاطرة ومبدعة في كل شئ طول السنة، ليش الفنية نزلتك لهذا المستوى؟! ايش صار في مادة الفنية؟)، وكان ردي: (ما أعرف!!) لأني فعلًا لم أكن أعلم وقتها أنني ((مثالية)) وأني لا أستطيع رؤية الألوان إلا وأطرافها حادة تمامًا، وفي كل استخدام لأي لون أقوم ببريها حتى تصبح حادة الطرف قبل إعادتها في العلبة، ناهيك عن ترتيبها داخل العلبة حسب الطول. لم أستوعب ذلك إلا عندما أصبحت ٢٧ عامًا. وقتها ربطت الأحداث وحصلت بعد عشرين عام تقريبًا على جواب لسؤال معلمتي الحبيبة: (ايش صار في مادة الفنية؟). والجواب هو: (أنا مثالية، لا أستطيع أن أترك الأمور حتى تكون على أكمل وجه وفي أفضل حال).
سامحك الله يا معلمة التربية الفنية لم تتسببي فقط في كرهي لمادة الفنية والرسم، حتى أصبحت لا أعرف كيف أرسم تفاحة إلى الآن، بل كان من الممكن بدلًا من تشكيل عقدة لدي من مادتك أن تعالجي صفة تسببت لي في الكثير من المعاناة على مر السنوات حتى وصلت للاحتراق الوظيفي بعمر ٢٧ عام – والذي تحدثت عنه في تدوينة استراحة محارب أم انتكاسة شغوف.
المثالية…آآآآآآآآآه. لم أعد أنطق هذه الكلمة إلا ومعها تنهيدة كبيرة. هي ليست كلمة من ثمانية أحرف بالنسبة لي، بل هي أشبه بثمانية جبال راسية بداخلي.
عندما شُخصت بالمثالية، نعم شُخصت، لأن هذه الصفة تُدخل الإنسان في حالة غير طبيعية يفقد معها أن يتقبل بأن يعيش بإنسانيته. لأن المثالية لا تسمح بأقل من ١٠٠٪، وتعتبر الخطأ خطيئة لا تُغتفر إلا بعد توبيخ شديد للذات وجلدها.
كنت في بداية الأمر رافضة تمامًا هذا التشخيص. وأذكر ردي للكوتش (كيف تقول أن اللي فيّ هو أني مثالية!. أولًا أنا مني مثالية ولا أسعى لأن أكون مثالية، وكيف أفكر حتى بهذا الموضوع فأنا كمؤمنة بالله أعرف أنه لا كامل إلا الله عز وجل. ولكن يهمني الإحسان والإخلاص في كل أمر أقوم به، وهذه الخصلتين من قيم ديننا وهي أيضًا قيم عظيمة بالنسبة لي).
في كثير من الأحيان نحن لا نعلم أننا لا نعلم، والتي تسمى حسب مفهوم نافذة جوهاري بالمنطقة العمياء. لم أكن أعلم أني أسمي الأشياء بغير أسمائها. فكنت أسمي المثالية بالإحسان، والطبيعة البشرية في الخطأ والنسيان بعدم المسؤولية واللامبالاة.
مما ساعدني على إدراك الأمر وتقبل التشخيص هو أني بدأت أرى الرابط العجيب. أتذكر عندما ذكرت الأمر لإحدى زميلات العمل وكنت أسخر وقتها: (تصدقي الكوتش قلي أنتِ مثالية) فنظرت إلي وقالت: (بس أنتِ فعلًا مثالية، أنتِ حتى المسافة بين الكلمة والفاصلة تنتبهي لها وتنرفزك وما ترتاحي حتى تعدليها). وبدأت اسمع أمثلة مشابهة من جميع من حولي، لدرجة أني قابلت صديقة عزيزة نعرف بعضنا من الصف الأول الابتدائي وبالمثل عندما ذكرت لها الموضوع، قالت لي بكل برود: (وايش الجديد! أنتِ من لما عرفتك من أولى ابتدائي وأنتِ مثالية) طبعًا ظننت أنها تبالغ حتى قالت لي: (أسماء أنتِ ومن سن صغير تنسقي الألوان في الكتابة في الدفتر فتحددي لون للعناوين الرئيسية ولون للعناوين الفرعية ولون للنصوص وتعرفي كيف تعيدي نفس الترتيب والمسافات وكأنك برنامج مايكروسوفت ورد).
بعدها وفي جلساتي مع نفسي في التأملات والمراجعة الدورية self-reflection تذكرت لحظات كثيرة كنت أهرب فيها إلى سريري وأقوم بتغطية وجهي بالوسادة وكأني بذلك اختفيت من الوجود، وذلك لمنع نفسي من بدء أمرًا قد لا أتقنه، أو المشاركة في أمر لن يكون مخرجه بجودة كافية أو إكمال عمل رغم رغبتي الشديدة في العمل على هذا الأمر. وأخيرًا وصلت للحظة (الأها) وفوضت أمري لله وتقبلت الموضوع ورأيت الرابط بين حرصي على بري الألوان الخشبية وإزالة المسافة بين الكلمات وعلامات الترقيم وهروبي للوسادات والكثير من المواقف الأخرى. وبدأت بعدها رحلة الخلاص من هذه الصفة (المثالية) وتبعاتها والتي سميتها بأسمائها الحقيقية لأستطيع التعامل معها.
هذه التدوينة هي المقدمة التي أردت أن يعرفها القارئ قبل سردي لرحلة التعافي، والتي سأشاركها في تدوينات قادمة بإذن الله. فبالتأكيد لن ينتهي حديثي عن هذا الموضوع على وجه التحديد في تدوينة واحدة، لأن رحلتي معها تساعد على تأليف فصول مجلدات من الممكن تسميتها (الاستنتاج والاستخلاص في رحلة الخلاص).
الرحلة في التدوينات التالية (والتي سيتم إضافتها بشكل تدريجي):
تدوينة: المعنى الكامل لأدوارك المختلفة في الحياة
تدوينة: يا أبيض يا أسود لكن مش رمادي – وهم أن تكون ١٠٠٪ على الدوام
وضعت لكم هنا إحدى فقرات (الرابط العجيب) التي كانت تُعرض على قناة سبيستون
دمتم في سلام







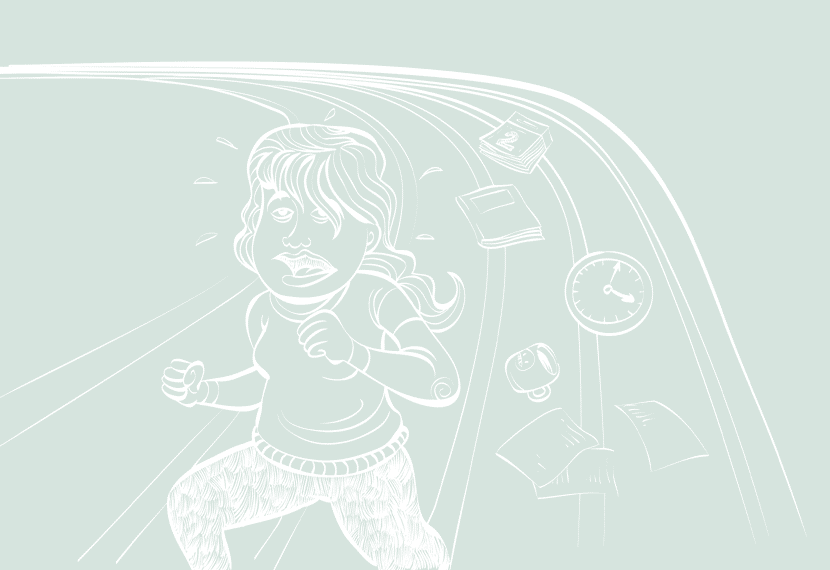

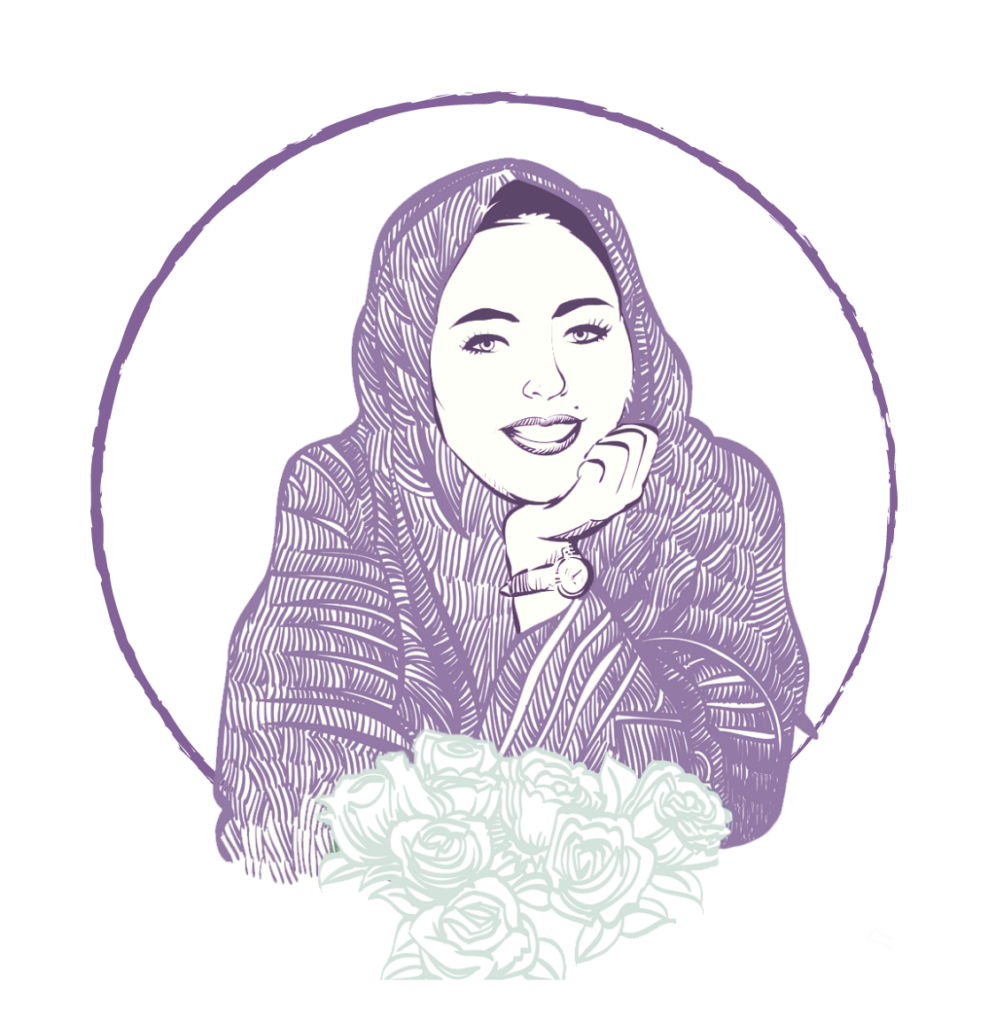

[…] هذا المفهوم هو أحد المفاهيم الأساسية التي ساعدتني في رحلة موازنة مثالية شخصيتي والتي تطرقت لها في تدوينة الرابط العجيب بين وسادات السرير وعلامات الترقيم. […]